الألسنية العامة بين الفلسفة والمنطقالمداخلة الأولى: في اللاهوت 12
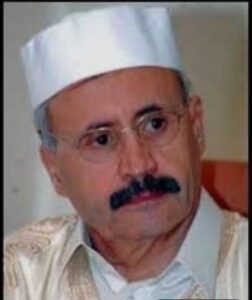
بقلم/ مهدي امبيرش
كل هذه المداخلات سواء تلك التي حول اللسان العربي ومنهج التفكير ومقاربته من خلال النحو والقواعد هي ضمن دراستنا للإنسان العربي،ضمن قراءة للإنسان بعامة،فاختلافالألسن هو اختلاف في منهج التفكير، وهذا، كماذكرنا في الحلقة السابقة، يدل على أن السلفية هي ظاهرة تاريخيّة،كما أنها تكشف عن عجز الإنسان في بعض أحواله على أن يتقدم في حركة التاريخ،هذا إذا اعتبرنا أن التاريخ نفسه ليس الوثائق، بل الإنسان نفسه، فاعل الفعل التأريخي، والهمزة على الألف نقصد بها أن هذا الفعل هو حادثة محدودة،أي أن تاريخ الإنسان هو جملة من هذه الوقائع، وأن الفعل في علاقة التضايف بالفاعل هو الذي يكشف عن وعي الإنسان،والوعي في العربية هو من الوعاء، أو الوسع، وبقدر المعارف التي يتحصل عليها الإنسان يكون وعيه، كما أن معطيات الزمان والمكان هي من الأركان الأساسية في إنجاز الفعل. هذا القول يمكن أن نجريه على تاريخ الإنسان بعامة، مع هذه الاختلافات على مستوى الواحد أو هذه التي على مستوى الشعوب والأمم.
إن المشكلة التي واجهت المؤرخين قديما وحديثا وتحت مسمى فلسفة التاريخ، تعد في ذاتها مشكلة، فإذا كان التاريخ المحدود محدودا بمعطياته فكيف لنا أن نقول بالتاريخ العام إن مقولة كروتشيه، التي سبق أنأشرنا إليها:(إن كل التاريخ تاريخ معاصر)، وعلى الرغم من أنها تخدم منهج التفكير الإيطالي، في حضارة سادت ثم بادت، وواقع إيطالي مر هي التي جعلته وميكافيلي الذي قال:(إن التاريخ يعيد نفسه) يحلمان بإمكانية إعادة حضارة الإمبراطورية الرومانية، ولهذا نعتبر الاثنين من السلفيين،الذين يرفضون واقع التقدم في الحياة، ولا يقابل هذين إلا موقف الذين يقولون إنهم واقعيون، وإن الحديث خارج الواقعة ليس علميا لأنه لا يمكن، حسب زعمهم، التحقق منه، حيث إن الحقيقة في نظرهم هي المتحقق فقط، وتجاوزا لهما يأتي الطوبيونأو دعاة العالم الافتراضي،فهروبا من الوعي وحركة التاريخ يقدمون تصورا يستعيرون له اليوم مصطلحا من اللغة السنسكريتية الهندية ومصلح الأفاتار الذي هو في المعتقد الهندوسي إمكانية تجسيد الإله، وهذه الأخرى مشكلة من مشاكل المعرفة القديمة المتجددة.
نرجع إلى المدرسة الإغريقيّة، وهنا نفرق بين النسب إلى الإغريق، أو إلى المحدود ضمن الإغريق. فسقراط وأفلاطون كانا أثينيين،وأرسطو كان مقدونيا،والطبيعيون من الإغريق، الذين عاشوا في آسيا الصغرى، هؤلاء الثلاثة يمثلون هذه المدارس المتجددة إلى اليوم والمرتبطة بمنهج التفكيرومن ثم بالأفكار وبوسيلة التعبير عنها،أي في علاقة منهج التفكير باللسان وعلاقة اللسان باللغة، سواء أكانت مصوتةأمرمزاأم إشارة أم علامة مع التذكير بالفروق التي سبق أن ذكرناها في مداخلات سابقة.
إن مايعرف بالفلاسفة الطبيعيين، من طاليس الذي قال إنأصل الكون الماء، والذي تأثر عند زيارته لمصر بدور نهر النيل في بعث الحياة في النبات والحيوانات والإنسان، وهو الذي قال (إن مصر هبة النيل) إلى انكسمندروانكسيمانس، وغيرهم من الذين قالو إن الكون هو نتاج الفيزياء أو الطبيعة، وكان آخرهم انباذوقليس الذي حاول أن يقدم إصلاحا بالقول إن حركة الكون تتم من صراع بين الثاناتوس، والايروس، حيث يمثل الأول الفوضى والخراب ويمثل الثاني الرخاء والنظام، وهذا التصور هو نتاج اللاهوت القديم الباقي إلى اليوم الذي أنتج الثنائية في الصراع بين قوتين، والذي بالضرورة للتخفيف من حدة الصراع يوجد الوسيط على تصور أن الكون في البداية كان ثنائية السماء والأرض التي تقتضي وجود فراغ لابد من ملئه، وهذا وجدناه يرتبط بالتعبير، كذلك حيث ذكرنا أن الخرافة اليونانية أوجدت هيرمس الذي هو نصف إله، فنصفه العلوي مرتبط بالإله زيوس أوثيوس، النظري أو المجرد،ومن ثم فإن لغة الإله لا يفهمها البشر، ويكون دور هرمس من يؤول هذه اللغة المجردة ويحولها إلى لغة مدركة، وهذا بداهة من الناحية الفلسفية يشكل بدايةلصراع كبير ظهر في أوروبا إلى اليوم والذي أنتج مدرستين، الأولى المدرسة المثالية الألمانية التي تقول بالمعرفة القبلية ويقابلها المدرسة المادية الوضعانية الفرنسية والأنجلو أمريكية، وهو ما يؤكد أن البشر يتقلبون ولا يتغيرون، فمازلنا نرى أثينا والخلاف الحاد بين سقراط وأفلاطون والمتكلمين الطبيعيين في آسيا الصغرى قائما إلى الآن، وأن دور هرمس هو ماحاول أرسطو أن يقوم به في إنزال صور أفلاطون المفارقة في السماء إلى الأرض أو اللغة المجردة المقدسة إلى لغة مدركة.إن هذا القول يحتاج إلى مزيد من التوضيح نعد به في المداخلات القادمة.


