أحلام مؤجلة.. حكاية جيل الأزمات
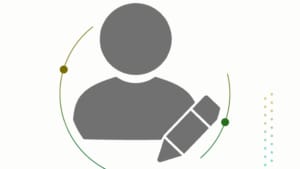
بقلم/ منيرة محمد
في زحمة الأزمات اليومية التي تحاصر الأسرة الليبية، من انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى انسداد الأفق السياسي وتقلب الأوضاع الأمنية، يظل سؤال جوهري يفرض نفسه بإلحاح: بماذا يحلم أبناؤنا؟ وهل ما زالت أحلامهم نقية كما كانت أحلام الأجيال السابقة، أم أن الواقع القاسي قد ضيّق آفاقهم وحصر تطلعاتهم في حدود المتطلبات الأساسية للحياة؟
لم يعد من المألوف أن يتحدث الطفل عن حلمه في أن يصبح طبيبًا أو طيارًا أو مهندسًا كما كان يحدث في الماضي. فحين يُسأل أحدهم اليوم عن أمنيته، قد يجيب بكل براءة أنه يريد كهرباء لا تنقطع، أو ماءً صالحًا للشرب، أو مدرسة مجهزة، أو أن يقضي صيفه دون أن يعاني من الحر الشديد. هذه الأماني، التي تبدو متواضعة في ظاهرها، تحمل في عمقها دلالات عميقة على التحولات التي طرأت على مفهوم الحلم لدى جيل نشأ في ظل أزمات متلاحقة وأوضاع مضطربة.
الدراسات النفسية والاجتماعية تشير إلى أن الأطفال الذين ينشأون في بيئات غير مستقرة، يميلون إلى صياغة أحلام قصيرة المدى، لأنهم لا يشعرون بالأمان الكافي للتخطيط للمستقبل البعيد. فتجدهم يضعون أهدافًا مرتبطة بما يمكن تحقيقه فورًا أو خلال فترة وجيزة، بعيدًا عن الطموحات البعيدة التي تحتاج إلى استقرار وظروف داعمة. وهذا ما يجعل أحلامهم انعكاسًا مباشرًا لمدى شعورهم بالثبات في محيطهم الأسري والاجتماعي.
ورغم ضيق الأفق الداخلي، تبقى التكنولوجيا نافذة مشرعة على عوالم أوسع. فبفضل الإنترنت ووسائل التواصل الحديثة، بات الأبناء يطّلعون على ثقافات وتجارب متباينة، ويشاهدون أنماطًا من الحياة تختلف جذريًا عن واقعهم. بعضهم يحلم بالسفر إلى الخارج، أو الالتحاق بجامعات مرموقة، أو تحقيق النجاح في مجالات رقمية مبتكرة، كإنتاج المحتوى أو العمل في تصميم الألعاب أو البرمجة. غير أن هذه النافذة، على رحابتها، تحمل مخاطر عدة، إذ قد تزرع في نفوس الشباب طموحات غير واقعية، أو تخلق فجوة بين الصورة المثالية التي يرونها على الشاشات، والواقع الذي يحيونه يوميًا، ما يولد الإحباط أو الشعور بالدونية.
ويظل للأسرة الدور الأبرز في توجيه مسار الحلم، إذ لا يقتصر الأمر على توفير متطلبات الحياة، بل يمتد إلى بناء بيئة مشجعة على التفكير الإبداعي والخيال الحر، حتى وسط الضغوط. فالحوار الهادئ مع الأبناء، وإشراكهم في أنشطة تثري مداركهم، وتشجيعهم على القراءة والاكتشاف، كلها ممارسات تزرع فيهم الثقة بقدرتهم على الحلم والعمل على تحقيقه. فالطفل الذي يرى والديه يسعيان بثبات نحو أهدافهما، يتعلم بالقدوة أن الحلم ليس رفاهية، بل بداية الطريق نحو الإنجاز.
إن الأحلام التي يحملها أبناؤنا اليوم هي المرآة التي تعكس حال المجتمع، فإذا كانت هذه الأحلام ضيقة ومحاصرة بالهموم اليومية، فهذا مؤشر على حاجة المجتمع إلى إعادة بناء ركائزه الأساسية، بدءًا من الأمن والتعليم والصحة، وصولًا إلى توفير بيئة تتيح للخيال أن ينطلق بلا قيود. وعندما يصبح الحلم مجددًا مساحة رحبة يتطلع فيها الطفل إلى أن يكون طبيبًا يعالج مرضى بلاده، أو مهندسًا يشارك في إعمار مدنه، أو فنانًا يضيف للثقافة الوطنية لونًا جديدًا، سنكون قد قطعنا شوطًا حقيقيًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
ولعل أعظم ما يمكن أن نقدمه للأجيال الصاعدة هو أن نمنحهم القدرة على أن يحلموا بلا خوف، وأن نهيئ لهم ما يجعل أحلامهم قابلة للتحقق. فالأحلام، مهما بدت صغيرة في بدايتها، قادرة على أن تكبر معهم، وأن تتحول مع الزمن إلى إنجازات تكتب صفحات جديدة في تاريخ الوطن. وإن جيلًا يملك الحلم، يملك الأمل، ومن يملك الأمل يستطيع أن يصنع الغد.


