الألسنية العامة بين الفلسفة والمنطق — المداخلة الأولى: في اللاهوت (6)
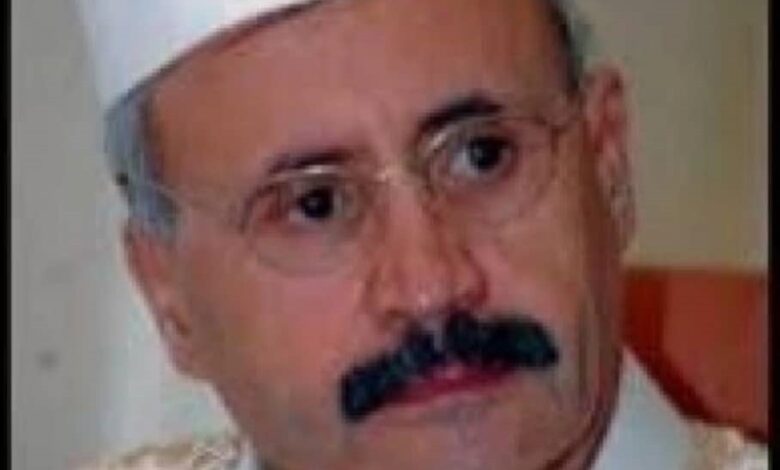
بقلم/ مهدي امبيرش
الذين تابعوا سلسلة هذه المقالات، بدءًا من حديثنا حول فلسفة اللسان العربي، إلى مقالاتنا في تقديم مقاربة بالسؤال الفلسفي «ما الإنسان؟»، وصولًا إلى هذه المداخلات حول اللاهوت، إنما يسيرون على نسقٍ واحد وإلى غايةٍ واحدة، وهي الكشف عن منهجٍ للتفكير العربي، في مقابل منهج التفكير الأعجمي، على أن نفهم العربية على أنّها عملية بيانية وفطرية في آنٍ واحد، وإنسانية كذلك. فكما علّمنا القرآن الكريم في فواتح سورة الرحمن أنه تعالى «خلق الإنسان، علّمه البيان»، فتعليمُ اللهِ الإنسانَ هو هذه الفطرة التي فطره الله عليها. وإنّ الإنسان، كما يتقدّم ويتفوّق على بدء خلقه من خواصّ المادّة الفيزيائية، أي من التراب والماء، إلى النفس؛ أي أن يصير مخلوقًا حيًّا خاضعًا لقانون الحياة، أي كافّة المخلوقات الحيّة بدءًا من النبات والشجر حتى الإنسان الذي يتفوّق بالروح التي نفخها الله فيه—مع ملاحظة أنّ التفوّق في العربية لا يلغي ما سبق—إذ يبقى في الإنسان شيءٌ من قانون الطبيعة المطبوعة، ومن قانون الحياة أو علم الأحياء (Biology). ثمّ يتفوّق الإنسان على هذين الطورين بالروح. وقد ذكرنا أنّ الله، بعد أن خلق الإنسان وسوّاه في أحسن تقويم، لم يأمر الملائكة بالسجود له إلا بعد أن نفخ فيه من روحه. وإذا كانت الروح لا ندرك ماهيّتها لأنّها من علم الله، وكان الإنسان المحدود غير قادرٍ على أن يدرك المطلق—وبداهةً فالله هو الذي أوجد المطلق—فإنّ ما ندركه هو تجلّيات هذه الروح من خلال قدرة الإنسان على الخلق، في حدود الممكن البشري، والإبداع، كما أنّه يتفوّق على الطبيعة بعد أن يكتشف في كلّ مرّة القوانين التي أودعها الله فيها، فيسخّرها لمصلحته.
نحن نتوقّع أنّ الذين تابعوا مقالاتنا في فلسفة اللسان العربي أدركوا أنّ «العربية» ليست جيلًا من الناس، بل وصفًا لهذا الجيل على أساس قدرته على الإبانة والتبيين والتبيّن في المستوى الإنساني. وكما تمّ هذا التفوّق يمكن أن يُرَدَّ الإنسانُ إلى دَرَكِ المخلوقات الحيّة فيخضع لقوانينها، وربما أدنى، ليخضع لقوانين الطبيعة الجبرية؛ أي يفتقد الإنسانُ قدرتَه على الوعي والإرادة وعلى الفعل الإرادي الواعي.
لقد ذكرنا في مقالاتنا حول فلسفة اللسان العربي أنّ الكلمة ليست اللفظ؛ فالكلمة مشيئة وإرادة وخَلْق، ومن ثمّ فهي كلمةٌ مسؤولة. والله—وله المثل الأعلى—خلق الكون بكلمة. ولهذا أفردنا أطروحةً لسانيةً عربية في الأبعاد التي يعطيها فعل الكينونة من خلال «كان» الفعل الناقص وتجليّاته: منذ زمن الصباح إلى المبيت، وكيف أنّ هذه التجلّيات تكشف عن تغيّرٍ من خلال فعل «صار»، وأنّ الأفعال الناقصة في «كان» لا نجدها في زمن الظهر، عندما تتعامد الشمس ويختفي الظلّ ويكون فعل الكينونة تامًّا؛ إلا أنّ هذا لا يبقى سرمدًا، فقد يبدأ الهبوط ويَحِسّ الإنسان بالخطر، فنجد في العربية الإصرار على الثبات من خلال أفعال: «ما زال، ما برح، ما فتئ» حتى زمن العصر، أي بداية قرب الظلام، والذي نجده في سورة «العصر» تنبيهًا للخسران المبين إذا استمرّ الإنسان في الهبوط حتى المبيت والظلام، في انتظار لحظة انفجارٍ في زمن الفجر الذي يؤذن ببداية فعل الكينونة في الصباح، والذي نزلت فيه سورة «الفجر»، وهي لحظةٌ زمنية مهيبة.
إنّ الذين يخرجون من كارثة الارتكاس في الظلام مرةً أخرى هم المؤمنون، حيث الإيمان بالغيب لا يحدّه الزمن. والغيب في العربية هو ما تحقّق وما يتحقّق وما سوف يتحقّق. وهذا الإيمان لا يتجلّى إلا بالعمل الصالح؛ إذ العمل في العربية أبعدُ من الفعل المحدود، وإنّ الوصف بالصلاح ينسجم مع الإيمان بالغيب؛ فالصالح ليس مجرّد النافع والمفيد، فقد يكون الفعل نافعًا، ولكن لا نقول إنّه صالحٌ إلا إذا امتدّ نفعُه إلى أبعد من المحدود.
لقد كانت المداخلة الفائتة تعيد القارئ الكريم إلى حديثنا عن اللاهوت، وكيف كانت النظرة إلى الكون—ولا تزال حتى اليوم—على أنّه ثنائية: السماء والأرض، أو الفكر والفعل، أو المقدّس والمدنّس، والتي تمخّض عنها القولُ بكلّ الثنائيات التي أوجدت الصراع المرعب؛ بدءًا من ثنائية الفكر والفعل، أو الرأس والبطن، إلى ثنائية الذكر والأنثى، أو السيّد والعبد، وهكذا. ولنا أن نقول إنّ الفكر الإنساني، منذ بدايته إلى اليوم، لم يخرج عن كارثة اللاهوت هذه، وإنّ محاولة البحث عن «الوسيط» هي محاولةٌ للفصل بين الضدّين دون التفكير في إلغاء الأسطورة التي برّرت هذا الصراع. ولأنّ ما ذكرنا يحتاج إلى توضيح، نُرجئ الحديثَ فيه إلى المداخلة القادمة.


