الألسنية العامة بين الفلسفة والمنطقالمداخلة الرابعة: في اللاهوت (4)
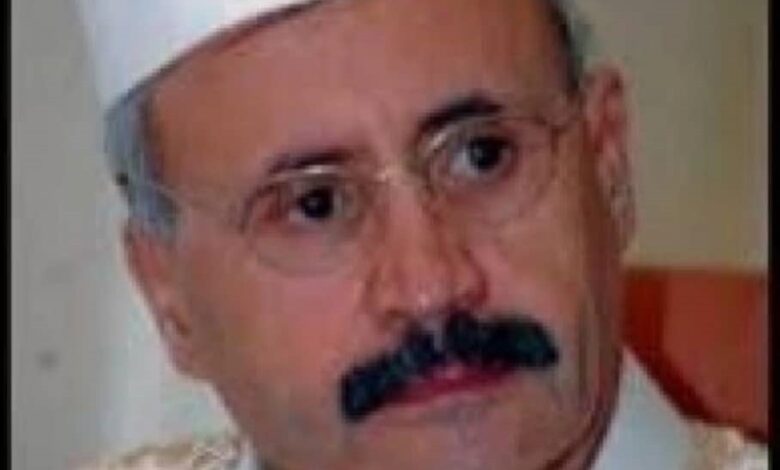
بقلم/ مهدي أميبرش
في المداخلة السابقة كنا قد أشرنا إلى أن الأزمة التي تواجه الإنسان هي أزمة منهج تفكير تأسس على جهل الإنسان نفسه، وأن هذه الأزمة بدأت منذ آدم عليه السلام، والتي — على الرغم من أنها كشفت عن أزمة — كشفت كذلك عن بداية للوعي الإنساني. لقد نسي آدم أنه أُسكن الجنة وزوّجه بمثابة دورة تدريبية من أجل أن يتحمّل هو وبنوه أعباء الاستخلاف في الأرض، على أن نفهم أن الجنة هي الأخرى على الأرض، وأن الاسم هو من الاختفاء أي أنها ستجنّ علينا وأن تختفي، ويكون مصطلح يحيلنا إلى مخلوق سبق آدم وهو الجن، والذي يدلّ هذا الوصف على أنه مخلوق لا يمكن للبشر أن ينظروا إليه إلا في حالة تجسّد وتمثّل، وأن التجسّد والتمثّل ليس هو، وهي ظاهرة يمكن أن ندركها. قلنا إنها في الدراسة اللسانية بمثابة اسم المعنى أو المطلق، وقولنا إنه المطلق الذي لا يحدّه المحدود.
لقد علّمنا القرآن الكريم أن جبريل عليه السلام تمثّل لمريم عليها السلام بشرًا سويًا، ولكن هذا التمثّل ليس جبريلًا، وهذا في الدراسات اللسانية يُحيلنا إلى أسلوب التمثيل؛ أو هذه المقاربة التجسيدية للمطلق ليست على وجه التحقق، وأن التمثيل ليس التشبيه، فالتشبيه إقامة علاقة معنوية بين طرفين، أي علاقة بين المشبه والمشبه به في محاولة لمقاربة المطلق أو اسم المعنى لعجزنا ونحن المحدودون. فإذا قلنا مثلًا إن فلانًا كالأسد أو إن خدَّ الفتاة كالوردة، فهذه العلاقة ترفض أولًا القول إن فلانًا أسدٌ؛ فالإنسان له خصائصه كما للأسد، ولكن قد يحكم البعض أن الأسد شجاع، ولكنه ليس الشجاعة. فالأسد الذي شُبّه به فلانٍ، الإنسان أقرب إلى اسم المعنى من الإنسان المشبه بالأسد، ولكن وجه الشبه — وهو الشجاعة — لم يصلها لا المشبه ولا المشبه به. كذلك فإن تشبيه خدِّ الفتاة بالوردة هنا نقصد الوردة ذات اللون الأحمر دون بقية الورود التي هي من جنس واحد ولكنها متنوعة، والتنوع ليس التعدد، وهنا يكون وجه الشبه (الحمرة) هو اسم المعنى الذي لم تبلغه الوردة المشبه بها، ولا خدُّ الفتاة المشبه.
وهنا، في المثال الأول، الذي قلنا إنه حكم محدود هو قضية، وقولنا إنه قضية قد نختلف في هذا الحكم أو نستأنف عليه، ذلك أن هناك من يرفض أن يحكم على الأسد أنه شجاع؛ لأن هذه الصفة صفة أخلاقية لا يمكن أن نصف بها الأسد الذي يراه البعض حيوانًا مفترسًا، وأن الوصف بالشجاعة لا ينصرف إلا إلى الإنسان باعتباره مخلوقًا أخلاقيًا؛ لأن وصوله إلى الإنسان هو طور أخير في التمام البشري، أي أنه قد تفوّق على المخلوق الحي في بعض خصائصه كما تفوّق المخلوق الحي على مادة خلقه الفيزيائية — التراب والماء — بتحوّلاتهما.
نعود إلى آدم عليه السلام الذي علّمه الله الأسماء كلها في علاقة بين الاسم والمسمّى، التي سوف تجرّنا بعد ذلك إلى قضايا كبرى في الاسم، والتي تأسست على منهج التفكير اللاهوتي. إن الملائكة بالتأكيد كانت تدرك هذه الموجودات التي أشار إليها الحقّ في قوله تعالى في الآية الكريمة:
﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: 31].
يعني أنَّ قولهم «إنهم سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء» كان حكمًا قائمًا على قياس تشبيهٍ بالمخلوقات التي سبقت آدم، ومنها الجنّ. وهذا المخلوق الجديد الذي نفخ الله فيه من روحه لا يمكن تشبيهه بالمخلوقات السابقة، وإن حكمهم الاستقرائي حكم خاطئ؛ وما عندهم من علم هو ما يخصّهم باعتبارهم ملائكة. بدليل أن هذه الموجودات التي أشار الله إليها في قوله «هَؤُلَاءِ» — والإشارة لا تكون إلا لموجودٍ مدركٍ — هم عاجزون في الأساس عن أن يقدموا لها أسماء، ومن ثم عاجزون عن تعلم العلاقة بين الاسم والمسمّى، وهي قدرة وهبها الله لآدم؛ فتعلم هذه العلاقة بين الاسم والمسمّى، وأن الله الخالق هو الذي منحها الأسماء المحدودة في علاقة الاسم بالمسمّى.
كان من المفترض أن يدرك آدم أنه محدود، وأن أحكامه ستبقى منطقية؛ حيث لا يمكن إصدار حكم إلا على محدودٍ محكَمٍ، كما في قضايا المحاكم. إلا أن آدم نسي نفسه ومهمته، فهو مخلوق مستخلف في أبنائه، وأن هذا الكمال سيتم عبر مسيرة معرفية محكومة بالتمام لا بالكمال، ربما سيصلها آخر إنسان على الأرض، وتكون مهمة آدم وبنيه قد اكتملت تمهيدًا ليوم القيامة. كان هذا النسيان سببًا لعصيان آدم، أي لتصلّبه ووهمه أنَّ المطلق سيحلّ فيه، وكما يقول الحقّ: “وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا” [طه: 115]. وكانت الفرصة سانحةً لأن يكون قابلاً للغواية من قبل إبليس، بأن يوهم آدم أنه بالإمكان تملُّك الخلد والملك الذي لا يبلى إذا اقترب من الشجرة المحرَّمة، فسيورثها آدم الكثير من أبنائه، كما ستبرز مشكلة الزمان والخلود وامتلاك مطلق الملك.
هنا كانت النتيجة افتضاح آدم وانكشافه وزوجِه من خلال التعري، كما هو مصير كل المتألهين من بعده، والهبوط؛ وتبقى الجنة بمثابة الفردوس المفقود أو المعنى المفقود الذي سيفتح أمامنا منهج التفكير اللاهوتي.


