خيانة النخبة.. مفكرون بلا منازل فكرية
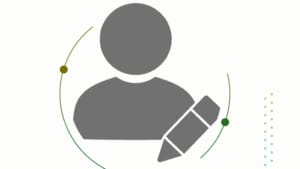
بقلم/ فوزية مراد
أستهل حديثي بمقولة للمفكر محمد أركون يقول فيها (لا يمكن لأمة أن تنهض ما دامت تقتل مفكريها أو تُسكتهم). السؤال هنا ما معنى أن تكون مفكرًا في أمة تخاف من التفكير؟
أن تكون مفكرًا يعني أن تجرؤ على السير عكس التيار، أن توقظ الوعي في زمن اعتادت فيه عقول الجميع على النوم الآمن في مستنقع الجهل، أن تعبر النهر وحدك، حين يختار غيرك الضفة الآمنة خوفًا من الغرق، ولكن أن تكون مفكرًا بلا وطن تسكنه فهذه مأساة معقدة ومركبة: فليس الفقد جغرافيًّا فحسب؛ بل هو خسارة كبيرة للملاذ الذي يفترض أن يستوعب فكرك، ويمنحك أذنًا صاغية، ويصون حريتك، وكما يقول نصر حامد أبو زيد: الوطن ليس الأرض، بل الحرية، فإذا سُلبت، صار الوطن قيدًا والمنافي ملاذًا.
وطنٌ لا يقبل اختلاف الرأي، ولا يسع فكرًا ناقدًا، سيكون قيدًا وبيئة طاردة للفكر كما قال نصر حامد أبو زيد، لا لكون السلطة تقمعه، بل البنية الثقافية والاجتماعية ذاتها قد تنقلب لنوع من السلطة التقليدية تقصي وتُكفر وتقتل كل من يجرؤ على كسر النظام القائم، وتاريخ الفلسفة زاخر بشواهد كثيرة منها: محاكمة سقراط وإعدامه ظنًا منهم أنه يفسد عقول الشباب ويزعزع النظام الاجتماعي، وجاليليو الذي دافع عن نظرياته العلمية وتم إكراهه على التنصل من أفكاره تحت التهديد بالعقاب، وابن رشد الذي نفي من قرطبة وأحرقت كتبه في بعض المدن الإسلامية رغم أثره الكبير في الفلسفة الغربية، والمفكر المصري عبد الرحمن بدوي الذي غادر مصر إلى باريس بعد تضييق الخناق عليه، قائلًا (أحسست بالغربة في وطني كما لم أحس بها في المنافي).
في أحيان كثيرة، النفي لا يكون خارج الحدود الجغرافية، بل نفيًا بالداخل: لا يقرأ له، لا يُدعى للحوار، لا يُناقش، يتجاهل وجوده، وهنا يكون أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن يعيش غربة داخل وطنه يذوب كظل في فضاء المجتمع، وإما أن يرحل إلى الخارج بحثًا عن وطن جديد يحتضن فكره وحريته.
ولكن المفكر الحقيقي لا يمكنه أن يتوقف عن التفكير، فالأفكار لا ترتبط بالجغرافيا كي تظهر وتنمو، بل إنها تحتاج عقلًا خصبًا منتجًا، وزمنًا ممتدًا صبورًا وفضاء يستقبله يومًا، فالمفكر هو من يصنع وطنًا له من خلال مقالاته، والفضاءات المعرفية والفكرية الآمنة التي يرتادها، حتى في حواره مع طلابه ومن يتقاسم معهم فضاء التفكير والتأمل.
الغريب في الأمر أن أفكار بعض المفكرين لا تنال التقدير والاحترام إلا بعد رحيل أصحابها (غياب الجسد) وهنا تحديدًا يمكن للفكرة أن تقرأ بصوت عالٍ ودون خوف أو تردد، والسؤال هنا: أيعقل أن يكون حضور الفكر مشروطًا بغياب صاحبه؟ وهل يظل المجتمع بحاجة إلى موت المفكر كي يحتمل فكره؟
صفوة القول: إننا في أمسِّ الحاجة لمناخ ثقافي يحتضن الجرأة الفكرية لا يخنقها، ويمنح السؤال مكانه الطبيعي في الوجود، فحاجتنا لهذا المناخ لا تقل عن حاجتنا للأمن والحياة والغذاء، فالمجتمع الذي يهمل طاقاته الفكرية ولا يستثمرها يخسر قدرته على التجديد ومواكبة الدول المتقدمة ويبقى رهينًا لأفكاره، وهنا يخسر قدرته على التجديد، ويظل عالقًا في اجترار الأفكار ذاتها والسرديات المنهكة حتى يأفل نوره.
أختم حديثي بمقولة للمفكر نصر حامد أبو زيد في كتابه التفكير في زمن التكفير يقول فيها (قد دفعت حياتي كلها ثمنًا لمحاولتي التفكير بحرية في مسائل يراها البعض محصنة، لكن ما معنى الوطن إن لم يكن فضاءً للحرية؟)


