الألسنية العامة بين الفلسفة والمنطق (المداخلة الأولى في اللاهوت)
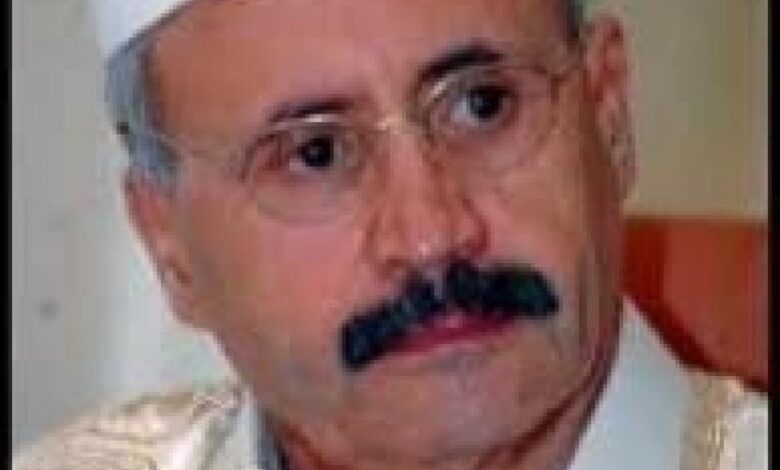
بقلم/ مهدي امبيرش
يقول الحق تبارك وتعالى في سورة الروم، الآية 22 ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ﴾، ذكرنا في مداخلات سابقة وفي تعريف الألفاظ والمصطلحات أن الآية تدل على موجود مدرك أو قابل للإدراك، وهذا خلاف الإشارة، أو الرمز، وفي هذه الآية نجد هذا الربط بين مفهوم الآية وبين خلق السماوات والأرض واختلاف الألسن والألوان، وهو ما كان من المفترض أن يفتح أمامنا عرب اللسان والمسلمين فضاءات للتفكير، وهذا ليس لنا فحسب، بل للعالمين جميعًا، فخلق السماوات والأرض واختلاف الألسن والألوان بعض من آيات الله الكثيرة، فالسماوات -كما علمنا الحق- هي في الأساس دخان، أي غازات، وأنها جعلت منها سبع طبقات يعلو بعضها بعضًا، وهي ترتفع أو تسمو على الأرض، ومن ثَم كان من المفترض أن نبحث في آية خلق السماء من دخان وغازات وخلق الأرض والاختلاف الفيزيائي سواءً في تركيب الدخان أم تركيب الأرض دون أن يعطي ذلك فرضية ثنائية السماء والأرض ما دامتا من جنس واحد ومن تنوع ظاهر، حيث التنوع غير التعدد وأن الظاهر ليس ثنائية الباطن كما يفهمها فلاسفة الظاهريات من أمثال إدموند هسرل، وهيغل، أي أن الظاهر هو دليل الباطن، هنا نقرأ هذا الاختلاف في الألسن على أنه آية أو علامة عظيمة على قدرة الله كخلق السماوات والأرض، كما نفهم الاختلاف بين الأمم في ألسنتها وألوانها على أنه كذلك تنوع ضمن الإنسان الجنس الواحد، وهو تنوع وظيفي مثل تنوع أعضاء الجسد الواحد، وهذا كذلك لا يبرر المساواة الحسابية، بل التنوع الوظيفي.
فالمساواة الحسابية التي يقول بها الماديون اليوم وعلى رأسهم اللبراليون، ليست سوى ضرب من الوهم والخرافة، ذلك أنها تستند على النظرية الذرية القديمة التي قال بها الإغريقي لوقيبوس، وديموقريطس، اللذان كانا يقولان إن العالم مركب من ذرات متساوية في الجوهر، حتى إن اختلفت في الشكل والحجم، وهو الذي تأسست عليه اللبرالية في مقولتي (independency)، و(individualism).
نعود إلى مصطلح اللاهوت، الذي نحيله إلى أزمة معرفية، قلنا في مقالات سابقة إنها أزمة الإنسان بعامة، منذ آدم وزوجه عليهما السلام، حيث كانا يطلبان الخلد والملك الذي لا يبلى، وقد ذكرنا في دراسات سابقة والتي عبر عنها القرآن بأنها نتاج النسيان الذي أدى إلى غواية إبليس لهما، ذلك أن القاعدة المنطقية تقرر أن المحدود لا يسع المطلق، وأن الله خلق كل شيء بقدر، ولا يكلف أحدًا إلا وسعه، فآدم وزوجه اقتضت المشيئة الإلهية أن يكونا مستخلفين في الأرض من خلال نسلهما، وليس من خلالهما، وهنا كان إسكانهما الجنة على الأرض إسكانًا مؤقتًا من أجل الإعداد للحياة عندما يهبطان من هذه الربوة العالية على الأرض إلى الأرض.
يقوم مصطلح اللاهوت (theology) و(theosophy) على فرضية إمكانية الوصول إلى المطلق، وهنا تبرز الأزمة مرة أخرى ، فاللاهوت بنوعيه أسلوبان أو طريقان للوصول إلى المطلق، وهذا أدى بعد ذلك إلى نظريات في الألسنيات العامة الذي سوف نتناوله.
يبدو أن مطلح (theo) أو (theos) يعود في اليونانية إلى زيوس أو ثيوس الذي يقولون عنه إنه رب الأرباب، ويتصورون في الخرافة الإغريقية أن هذا الرب مقيم في السماء، ولأن السماء تبدو لهم عالية فلا بد أن يفكروا في وسيلة تبدو خرافية، كالتي قال بها الزرادشتيون، من أن نبيهم زرادشت صعد إلى السماء للالتقاء بالرب، ولأنه تصور خرافي، فلن تكون الوسيلة إلا خرافية، حيث تقول إن زرادشت امتطى حيوانًا بين البغل والحصان صعد به إلى السماء، وهي نفس الخرافة التي أقحمها الفرس في خرافة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم، سوف نرى أن هذا الحصان الخرافي يتحول إلى جدل صاعد وآخر هابط عند اللاهوت أفلاطون، فالثيولوجي يتم إذًا على أن المطلق أو الرب موجود في محدود ظرفي (السماء) وبهذا يتم إدراكه بالمنطق أو اللغوس، في حين أن الثيوصوفيا تقوم على أساس أن النفوس كانت مفارقة في عالم المثل في السماء، ولكنها سقطت عندما فقدت أجنحتها القدرة على التحليق والسير في موكب الآلهة، ومن ثم لابد من تجريدها من المادة كي تعود إلى السماء، وهو ما بنيت عليه شطحات الصوفية وطقوس التطهير، ويمكن القول إن سقراط وأفلاطون كانا لهوتيين، وقد جمعا، خاصة أفلاطون، بين الثيولوجي والثيوصوفي.


