عود على بدء.. الإنسان واللسان
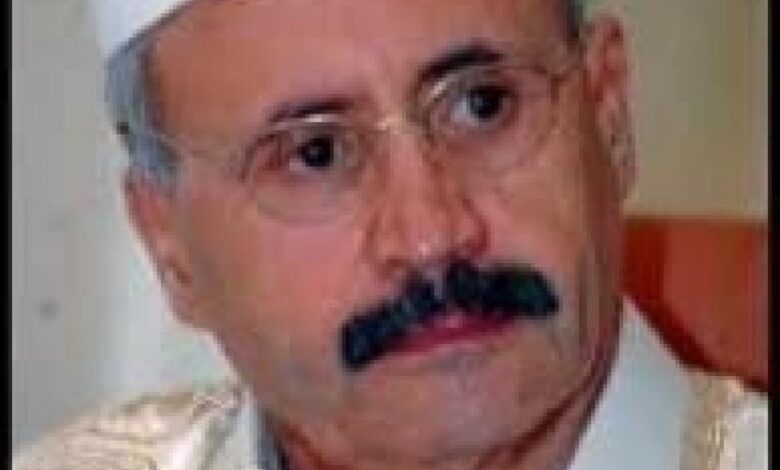
بقلم/ مهدي امبيرش
أرجو قراءة هذه المداخلة خارج المواقف الشخصية والتعصب: متى يصير جيلنا عربيًّا؟ في مداخلات كثيرة، ونحن نتحدث عن عبقر حدية اللسان العربية، حيث اللسان استعارة مجازية، ليست هذا العضو أو الجارحة، بل الذي هو منهج التفكير لأمة من الأمم، وتكون اللغة الوسيط أو السبب الذي تعبر به الأفكار المحفورة في الذهن، الذي قلنا إنه المعمل الذي يتم فيه إنتاج الأفكار، ومن ثم يكون الذهن أبعد من العقل الذي هو قدرة من قدرات الذهن، فمهمته وضع حدود مفهومية تاركًا الأحكام لقدرات الذهن الأخرى، كالتدبر والتفكر والتصور والتخيل، وكثير منها لا تقع ضمن حدود العقل، والإبداع خارج العقل، أي أنه لا معقول، كالتخيل والتصور، وما إليهما.
هنا يكون من الأهمية بمكان أن نعيد القراءة في اللسان العربي، لنكشف عن هذه القدرة التي قال فيها الحق إنه “لسانٌ غيرُ ذي عوج”، وإنه مُبين، أي بيِّنٌ في نفسه، مُبِينٌ لغيره. وهو غير اللغة. فهنا يُقال: اللسان العربي، لا اللغة العربية؛ أي إذا كانت اللغة لا تكشف عن اللسان، أو أنه لا يُعبَّر من خلالها، فلا أهمية لها.
دعونا نوضح أكثر: إن أهمية اللسان العربي تكمن في كونه يكشف عن علاقة عضوية، أي تكوُّن لا تركيب. بينما في الأعجمية، يتأسس البناء على منهج تفكير مادي ذرّي يقوم على الاستقلالية. وهذا ما يُطلق عليه لديهم “الفونيم” (Phoneme)، أي الوحدة الصوتية، التي لا مفهوم لها إلا إذا رُكّبت ضمن “المورف” (Morpheme)، فيعطيها طابع الشكل التركيبي (Morphology).
أما في العربية، فإن منهج التفكير يتأسس على الخلايا، أي على العلاقة العضوية. ويكون لكل حرف مفهومه، ومن حيث البناء، تكون العلاقة داخل الكلمة علاقة عضوية، كما في جسد الإنسان الواحد، يكون الاختلاف فيه اختلافًا وظيفيًّا. وهذا ما قلناه عن العلاقة التكوينية، لا التركيبية القابلة للتفكيك.
وتكون العلاقة في المجتمع انعكاسًا لذلك: لا علاقة فردية ذرّية استقلالية كما في الأعجمية، التي حوّلت الإنسان إلى فرد مستقل (individual) في حالة انفصال (division)، نتيجة لذلك المنهج الذرّي في التفكير.
وهنا نفهم مقولة اللساني السويسري دو سوسير، أحد مؤسسي “التركيبية”، التي تُترجم إلى العربية – على غير دقة – بأنها “البنيوية”. فهو يعترف صراحة بأن العلاقة داخل اللفظ في اللغات الأوروبية علاقة اعتباطية، وأن كل فونيم لا مفهوم له إلا بالتركيب الشكلي (المورفولوجي) مع فونيم آخر. والتعامل هناك يكون عبر “الأصوات”، ثم نبحث في “الصوتيات” (Phonetics)، لا في منهج التفكير، كما نفعل نحن.
ولا علاقة للنحو، الذي هو نحو الذهن ونظام تفكير، بالقواعد، التي هي مجرد فرع منه. أو قل: النحو هو “البيت”، بينما القواعد هي تفاصيله.
ولا علاقة للسان باللغة فقط، فالعودة إلى اللسان تعني العودة إلى منهج التفكير ذاته، لا إلى اللغة بمعزل عن الفكر.
وهنا نصل إلى النتيجة، وقبلها نمرّ على مسألة “الجيل” من حيث دلالات الحروف في الذهن. فـ”جيلًا من الناس” ليس كما يتوهم البعض، فترةً زمنيةً تُقدَّر بمائة عام، أو علاقة جينية فقط. بل هو انتماء إلى أمة، حيث “الأم” في العربية تدل على التملك، و”الفنون” تدل على الموجودات.
فيكون العرب “جيلًا من الناس”، وكذلك الأتراك، والفرس، وغيرهم. ولكن السؤال المحرج لنا: متى يكون العرب جيلًا من الناس؟
هل فقط لأنهم يتحدثون لغة تُوصف بأنها عربية؟
أنا لا أرى ذلك. إذ ليس في مقدور الإنسان أن يتعلّم لغةً خارج لسان أمّه، إلا إذا تعلّمها كلغة لا كمنهج تفكير. وقد يتقن قواعدها، لكنه لا يحمل لسانها ولا يحمل عقلها.
نحن الآن نتحدث لغة توصف بأنها عربية، ولكننا لسنا جيلا عربيا، أو أمة عربية، ولو كانت اللغة تصنع الأمة والجيل لكان الملايين اليوم ممن يتحدثون الإنجليزية إنجليزا، نحن نتحدث لغة بيانية عربية أي واضحة ولكن بلسان أعجمي، اللغة هنا لغة نفعية لا لسان أمة ومنهج تفكيرنا، نفكر على ملة الأعاجم ونقرأ على ملة الأعاجم، حتى القرآن الكريم لا تفهمه لسانا عربيا بل لغة، أي تقرأه أعجميا وعربيا، حتى أن أغلب فهمنا للقرآن فهم أعجمي والتفسير أعجمي والفرق أعجمية والخرافات والأساطير منقولة عن الأعاجم، وتكون النتيجة ما علمنا إياه الرسول الكريم من قوله: (ليست العربية لأحدكم بأب أو بأم إنما العربية اللسان) فهل نحن لسان واحد، ومنهج تفكير بياني واحد وأم واحدة؟ لنقول: إننا أمة عربية، أم نحن أعاجم في ثوب عربي؟


